د. العياشي ادراوي. أستاذ التعليم العالي. جامعة محمد الأول
وجدة. المغرب
تقديم:
لا شك أن ساحة الفكر الإسلامي الحديث عرفت وتعرف توافد العديد من النظريات والمناهج والمفاهيم الغربية، استهوت بشعاراتها البراقة وطابعها التجديدي الكثير من المفكرين المسلمين، فصاروا يدافعون عنها ويناصرونها ويعملون على نشرها من خلال توظيفها في قراءة الموروث الإسلامي ومناقشة قضايا الوحي والنص، واقتحام مسائل الدين والإيمان وما شابهها؛ دونما تمحيص أو نقد للخلفيات والمرجعيات الثاوية وراءها، ولا قراءة في الأبعاد والمآلات الموجهة لها، الأمر الذي يخلق إشكالات على مستوى التصور والتنظير، وتضارُباً على صعيد الأجرأة والتطبيق، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالاشتغال على نص مؤسس يمثل دعامة العقل الإسلامي وصلبه؛ بحيث تشيد وفقه المعايير، وتقام على ضوئه القيم، وتبنى على هديه التشريعات والقوانين مثلما هو الحال مع النص القرآني.
حسبنا في هذا البحث أن نوضح المعالم الأساسية لنظرية الهرمينوطيقا الحديثة التي طرحت في مجال فهم النصوص وتفسيرها وتأويلها. مما جعل أثرها أبلغ – أكثر من غيرها- في جملة من البحوث المعاصرة حول المعرفة الدينية وقراءة النص الديني فهما وتأويلا. وخاصة تلك التي تخطت “قدسية النص إلى نصية النص”، أو لنقل رامت تجريد النص الديني من قدسيته وحقانيته. لذا نرى من المناسب في هذا السياق إبراز خلفيات هذه النظرية واستعراض أهم مراحل تطورها للتحقق من مدى ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لمقاربة النص القرآني من حيث هو نص؛ له منطقه الخصوصي وسماته الفارقة. ومن ثمة الانتهاء إلى جملة من الاستنتاجات والخلاصات.
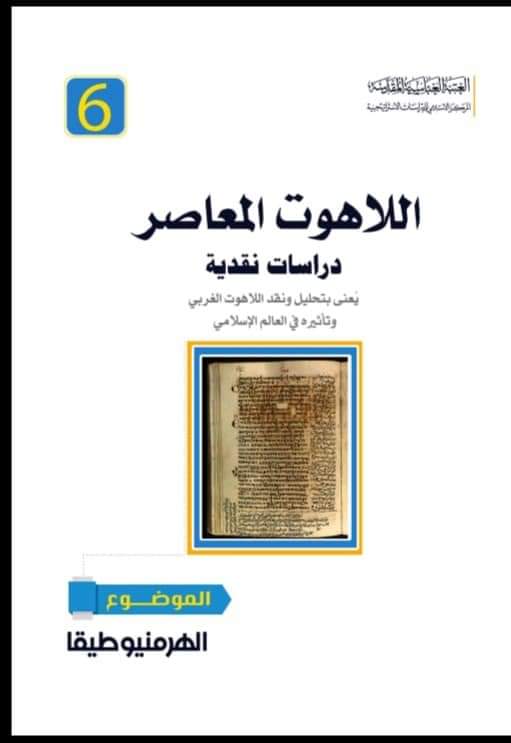
- في مسمى الهرمينوطيقا:
يعود مصطلح الهرمينوطيقا (Hermeunitics) أو علم التأويل – كما يصفه البعض- إلى الأصل الاشتقاقي اليوناني (Hermeneuein) الذي يؤدي معنى الإظهار والترجمة والتفسير. وقد ذكر بأنه مشتق من “هرمس” في اليونانية؛ وهو الملاك الذي ينقل رسائل الآلهة من بعضهم إلى بعض. وفي الوقت نفسه يساعد البشر – حسب ما كانت تقضي به بعض الأساطير اليونانية- على فهم الرسائل الرمزية للآلهة.[1]
و على المستوى الإجرائي يبقى أرسطو أول من وظف مصطلح هرمينوطيقا في باب “منطق القضايا” من كتابه “الأورغانون”. أما في القرون الوسطى فقد استعمل المفهوم للتعبير عن معنى التفسير والتأويل المرتبطين بالكتاب المقدس. إذ يحيل على جملة من المبادئ والقواعد التي يتعين أن ينضبط لها المفسر لأجل الوصول إلى معنى النص الديني[2]. وتبعا لهذا فإن مصطلح الهرمينوطيقا – في أصوله البعيدة- مصطلح مدرسي لاهوتي تقترن دلالته بذلك العلم المنهجي الذي يهدف إلى فهم وتفسير نصوص الكتاب المقدس التي تتطلب فهما، والتي يشعر المتلقي لذلك باغتراب إزاء معناها. بمعنى أن الهرمينوطيقا رامت منذ البداية أن تنفذ إلى عمق “الوجود النصي”. لذا لم تتورط في مفهوم الشكل أوالبناء اللغوي المنغلق على ذاته أثناء عملية تفسيرها للنصوص، حتى أن “دلتاي” – أحد أقطاب الفلسفة الهرمينوطيقية – يؤكد في مؤلفه “نشأة الهرمينوطيقا” أن فن الفهم يتمركز حول تفسير بقايا الوجود الإنساني المحفوظة في الكتابة[3].
وبالرجوع إلى مقالة جان بيبان J.Pépin ” الهرمينوطيقا القديمة” L’herméneutique ancienne (1975) التي عني فيها باستقصاء دلالات الفعل (hermeneuein)وأصوله الاشتقاقية، نجده قد أشار إلى أن “ترجمة المصطلح الإغريقي إلى اللاتينية ب (Interpretatio) قد لعب دورا سلبيا في “الهرمينيا” (herminia) بأن اكتسبت عبر السابقة (Inter)معنى التدخل والتوسط. وهو معنى شكل انحرافا دلاليا عن فالكلمة والتي لم يكن لها في صيغتها اللغوية ما يحميها من ذلك. لذا كان معنى المصطلح الإغريقي دالا على التأويل. وهذا ما أدى أيضا إلى أن تصبح الهرمينوطيقا لاحقا مرادفا للتفسير (L’exégése) في حين يرى “بيبان” أن المعنى الأصلي لعبارة (hermeneuein) والكلمات المنتسبة إليها ليس التفسير باعتباره فعل دخول في قصدية النص أو الرسالة، بل إنها تعني غالبا فعل تعبير (Expression) الذي يتميز بطابع الانفتاح الخارجي”[4].
وتبعا لهذا تبدو مهمة الهرمينوطيقا ليست مقتصرة فقط على فهم النصوص وتأويلها، وعلى الاجتهاد في تخريج معانيها أو محاولة الوصول إلى معنى خفي حقيقي، أو الانتقال من المعنى المجازي إلى مراد المتكلم، وإنما تعتبر أن النص يحتمل معنى بصورة افتراضية، مبررة ذلك بكون القراءة ليست مجرد فك شفرة النص أو سننه، كما كانت ترى المذاهب التأويلية القديمة، بل هي ذلكم النص في إطار الهواجس المعرفية والوجودية التي يحملها[5]. وعليه فإن الانعطاف الأساس الذي عرفه مسار الهرمينوطيقا – استنادا إلى ما سبق – إنما تمثل في الانتقال من إشكال “ما هو معنى النص؟” إلى إشكال آخر مغاير هو “ما الفهم؟”[6] وهما إشكالان يحددان – على التوالي – التمايز القائم بين اهتمامات الهرمينوطيقا في صورتها الكلاسيكية، و الهرمينوطيقا الحديثة التي نحن معنيون بها في هذا البحث أكثر من غيرها.
إن الإطار المعرفي لأصل مفهوم الهرمينوطيقا إذن هو إطار فلسفي في مقام أول، على الرغم من أن السياق الديني والفضاء اللاهوتي هما اللذان احتضناه وأكسباه امتلاءه الدلالي من خلال إثارة بعض قضايا المعنى والتأويل ذات الصلة بقراءة وتفسير النصوص المقدسة اليهودية والمسيحية تحديدا. فالعمق النظري والبعد الفلسفي إنما تحددا عبر جملة من المحطات التي تمثلت في التطورات الحاسمة التي شهدها الوعي الفلسفي الأوربي، إذ هي التي رسمت تاريخ تطوره وتحولاته[7]. كما سنقف على ذلك بشيء غير قليل من التفصيل في الفقرات القادمة.
وللاستدلال على ما ذهبنا إليه من كون “النظر الهرمينوطيقي” مدينا في تطوره إلى البحث الفلسفي وإن كان منبته دينيا، نكتفي باالإشارة إلى أن ظهور الهرمينوطيقا –كما هو ثابت في تاريخ الفكر الفلسفي- إنما ترافق مع تأويل النصوص الدينية المقدسة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. كما أن الأسئلة التي طرحت آنذاك على تلك النصوص كانت مرتبطة في مجملها بمشاكل التوفيق بين العهدين القديم والجديد أو بين التشريعات الإلهية ونواميس الطبيعة، أو بين الخوارق والانتظام، بل وحتى بين الأساطير الإنجيلية والوقائع التاريخية. فيما ظهرت هرمينوطيقا الأنوار في صورتها الدينية لتحقيق مسعى التوفيق بين معاني النص الديني وصورة العالم الجديدة في عصر الأنوار[8]، وكلها ذات طابع فلسفي بامتياز.
ولاشك أن هذا التفاعل بين الديني والفلسفي في نطاق الدرس الهرمينوطيقي، عبر تاريخه المتموج مكن من الانتقال من الهرمينوطيقا القديمة (أو علم التفسير) المرتكز على وحدة المعنى الصحيح ووحدة الحقيقة اليقينية إلى الهرمينوطيقا المعاصرة التي فتحت الفهم الإنساني على تقبل فكرة تعددية المعنى ونسبية الحقيقة. وبالتالي يمكن القول إن الهرمينوطيقا المعاصرة هي نتيجة لواحدة من القطائع الإبستمولوجية التي أحدثت (بضم الهمزة) في الوعي والفكر الغربيين للتعاطي مع العالم ولتصور الحقيقة والمعنى. وخاصة في مجال العلوم الإنسانية التي كفت منذ القرن التاسع عشر عن أن تتخذ المنهج التجريبي الوضعي نموذجا وحيدا في التفسير والتنظير[9].
- في تطور التفكير الهرمينوطيقي:
يجمع أغلب المشتغلين بالفلسفة في العصر الراهن على أن توظيف مصطلح “هرمينوطيقا” للتعبير عن ذلكم المنحى في البحث الفلسفي الحديث الذي يهتم “بنظرية الفهم”، بغض النظر عن طبيعة موضوع الفهم؛ فقد يكون نصا دينيا أو دنيويا، منتوجا كتابيا أو شفهيا، وقد يكون عملا فنيا أو ظاهرة اجتماعية أو غير هذا. كما يجمعون على أن ظهور الهرمينوطيقا بوصفها نظاما فلسفيا مستقلا حائزا ما يكفي من مقومات “النظرية”، يتجاوز في أغراضه ومراميه نطاق التفسير الضيق للنصوص الدينية، لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر؛ بحيث ارتقى إلى مرتبة المجال الفكري القائم بذاته، بل دخل مرحلة التطور والتجديد انطلاقا من التغيرات العميقة في إشكاليات الطرح الفلسفي التي شهدها القرن العشرون[10].
وعلى اعتبار أن الكلام يضيق بالتعريج على كل المراحل التي قطعها مسار التفكير الهرمينوطيقي، حتى لو رمنا الانتقاء والانحصار في أهمها – بالحديث مثلا عن مرحلة الهرمينوطيقا اللاهوتية التي جعلت مركز اهتمامها النص المقدس في العهد القديم، أو الهرمينوطيقا “الدنيوية” التي اهتمت بالأدب الكلاسيكي الإغريقي واللاتيني، أو حتى الهرمينوطيقا القضائية التي عنيت بالمبادئ والقواعد التي تمكن من التطبيق السليم للقواعد والتشريعات – على اعتبار أن ذلك كذلك فإنا سنكتفي بالوقوف عند بعض المحطات الأساسية للهرمينوطيقا المعاصرة لرصد كيف تطور “سؤال فهم النص” من محطة إلى أخرى، ومن ثمة الانفتاح على نقد تداعيات الدرس الهرمينوطيقي (في صورته الغربية) على النص الديني الإسلامي.
- شلايرماخر وتقويض موضوعية الفهم:
إن إحدى الإشكالات المربكة في الفلسفة الغربية تبقى تلك التي طرحها “إيمانويل كانط “وهو يجتهد في حل مشكلة الميتافيزيقا بخصوص مدى قدرة العقل على الإحاطة بالظواهر. ومن هنا فإن تأكيده على أن “العقل لا يدرك إلا عبر قنوات تسبق التجربة” قد زعزع الثقة شبه المطلقة بالعقل التي كان رسخها ديكارت وعززها التنوير. إن “أزمة العقل” إنما تتجلى أساسا في نظرية فهم النص التي وضع أسسها اللاهوتي والفيلسوف فريدريك شلايرماخر (ت 1834)[11]، الذي يعد بحق مؤسس الهرمينوطيقا، على اعتبار أنه مارس نقدا جذريا للهرمينوطيقا اللاهوتية التقليدية التي لم تكن – في نظره – سوى تجميع قواعد في التأويل بعيدة كل البعد عن أي تأصيل منهجي من جهة، ولافتقارها للضوابط النظرية العامة التي وفقها يستقيم التأويل والفهم من جهة أخرى. وانسجاما مع هذا يرى “بيتر زوندي “(Peter Szondi) أنه “لمعرفة نظرية الفهم عند شلايرماخر ينبغي الاعتناء بالاعتبارات المتصلة بالتطبيق الفعلي للفهم، وبمشروعه في تأسيس هرمينوطيقا جديدة قائمة على ملاحظة مواد اللغة”[12].
فهو ينظر إلى اللغة بوصفها كلا لا متناهيا. وتماشيا مع الإرهاصات الهرمينوطيقية اليونانية يرى أن فهم النص يتجاوز رصد العلاقات النحوية بين أجزائه إلى مركبة يدعوها “نفسية”. لذا فإن وظيفة الهرمينوطيقا عنده تكمن في إعادة تركيب العملية الإبداعية التي دارت في خلد واضع النص. ولما كان الكثير مما هو غير واع لدى المؤلف يصبح واعيا لدى المفسر فإن ذلك ينزع الأخير إلى فهم النص أفضل من موجده[13].
وتأسيسا على هذا تغدو عملية التأويل عند شلايرماخر مرادفة ل”إعادة البناء” (reconstruction) التي تتخذ صورتين اثنتين متكاملتين: تأويل نحوي (Interprétation grammaticale) ؛ الذي يتوخى فهم خطاب معين انطلاقا من العناصر اللغوية وطبيعة العلاقات التي تنتظمها. ثم تأويل تقني أو نفسي (psychologique)؛ ومداره تلك الخصوصية أو الكيفية التي ينبثق بها الفكر من داخل الإطار الكلي المميز لحياة المؤلف (واضع النص) النفسية والتاريخية. بمعنى أن فهم نص ما – وفق هذا التصور- هو إعادة بناء تلك الحدوس الأصلية للمؤلف الذي أنتج النص؛ بالتركيز على اتجاهه ونفسيته وأسلوبه من ناحية، وظروف حياته من ناحية أخرى. لذا يصير الفهم من هذا الجانب – على حد تعبير غادامر- بمثابة “إعادة إنتاج للإنتاج الأصلي، أو هو خلق جديد لأول خلق”[14]. وعلى هذا الأساس يكون الهدف الأسمى الذي تسعى الهرمنوطيقا إلى تحقيقه ليس الوقوف على معنى النص كما كان الأمر مع الهرمينوطيقا الكلاسيكية، وإنما فهم الكاتب (موجد النص) بما هو ذات منتجة مبدعة. وفي هذا الإطار نجد شلايرماخر يتوسل بمفهوم “التخمين”(la divination) قصد إعادة بناء الخطاب المعطى بصورة تاريخية حدسية-تنبؤية وموضوعية في الآن نفسه[15].
إن بنية الفهم إذن عند شلايرماخر تروم الخروج من مجال البحث عن المطابقة والمماثلة التامة إلى نطاق الاختلاف والمغايرة الكلية؛ أي الانتقال من ضيق مجال معرفي قديم مؤسس على مركزية المعنى إلى أفق جديد –عبر قطيعة معرفية- هو مجال لا مركزية الفهم[16].
- هايدجر واكتشاف المخفي في النص:
إذا كان شلايرماخر قد ارتقى بالهرمينوطيقا إلى مرتبة الاستقلالية الإبستمولوجية، بجعلها فرعا فلسفيا خاصا يعنى بكيفية فهم النصوص وتأويلها، فإن الفيلسوف مارتن هايدجر (ت 1889) قد أدخلها في نطاق التقصي الفلسفي الوجودي معتبرا أن الفهم ليس مجرد بنية معرفية وإنما يشكل واحدة من البنيات الأساسية للوجود. فعلى خلاف ما بني عليه المفهوم التقليدي القاضي بكون الفهم ينشأ من التفسير، أوضح صاحب “الوجود والزمن” أن الفهم كامن في تربة الوجود الإنساني على نحو يسبق أية عملية تفسيرية. الأمر الذي يجعل كل الأشياء تتميز بميزة جوهرية وهي “المفسرية” (القابلية للتفسير)، بمعنى أن هذه الأشياء لا تبدو عارية مجردة، وإنما مفسرة؛ من حيث هي تؤدي هذه الوظيفة أو تلك، وتقوم بهذا الدور أو ذاك[17]. ومن هنا فإن الهرمينوطيقا في حيز اعتقاد هايدجر هي “نظرية الفهم” نفسها، إلا أن هذا الفهم له معنى خاص عنده؛ أي هو القدرة على إدراك إمكانات الذات للوجود في سياق حياة المرء، ووجوده في العالم. لذا يصير الفهم ليس شيئا يمكن امتلاكه والتمكن منه، بل هو شكل من أشكال الوجود في العالم، أو عنصر مؤسس لهذا الوجود؛ بحيث يمكن (بفتح الميم) من ممارسة الفهم بالفعل على المستوى التجريبي[18]. وبهذا الاعتبار يكون الفهم – من الناحية الوجودية – أمرا ضروريا من جهة، وسابقا على أي فعل وجودي آخر، من جهة ثانية.
إلا أن ثمة بعدا آخر للفهم – في نظر هايدجر – هو أنه مرتبط بالمستقبل مما يجعل النصوص والخطابات ليست مكتفية بذاتها أو كاملة في نفسها وإنما هي قابلة لقراءات متعددة، وحمالة لدلالات متكوثرة ينتقل وفقها التأويل من طور إلى آخر، وينمو المعنى تبعا لذلك في صورة من صور إغناء النصوص وإثرائها بحسب مقتضيات زمن تلقيها والتفاعل معها، لذا لم يكن غريبا أن يؤكد هايدجر “أن الفهم فعل تاريخي، بمعنى أن النص – أي نص كان – لا يفهم إلا في سياق متطلبات العصر. ومن هنا فإن الفهم يرتبط دائما بالزمن الحاضر ولا وجود له خارج التاريخ، وأن المفسر له فهم خاص يرتبط بعصره، يجب ألا ينفك عنه (بل لا يستطيع ذلك) ليقوم بتفسير النص وفقا لفهم العصر السابق.”[19]
وغير خاف أن الطرح الفلسفي لهايدجر في هذا السياق ينطوي على قدر من الجدة مقارنة مع نظرية الفهم الكلاسيكية، على اعتبار أن الفهم نشأ تحديدا من سؤال موضوع على النص يتعمق باهتمام متأصل في حياة المفسر وخبرته، بحيث أن كل فهم يستند إلى فهم مسبق لما يمكن للنص أن يقوله، أي إلى علاقة حياتية بين المفسر والمسألة التي يتطرق إليها النص[20]. وعليه فإن الإنجاز الهرمينوطيقي الأهم لهايدجر – على هذا المستوى – هو اكتشافه ما هو ثاو بشكل مسبق خلف التعبير اللغوي في خبرة الفهم الإنسانية، على حد تعبير جون غروندين[21].
2-3- دلتاي والتحرر من سلطة المتعالي:
إذا كنا أشرنا إلى أن هايدجر ينظر إلى الفهم على أنه “فعل تاريخي” فإنه في تصور “ولهام دلتاي” (Dilthey.w) (1833-1911) تم الارتقاء به إلى مستوى أكثر شمولية، الأمر الذي كان له تأثير كبير على النظرية التأويلية اللاحقة برمتها. إن التاريخ في تصوره يتحقق فيما يتولى الإنسان على الدوام امتلاك التعبيرات المصوغة التي تشكل إرثه وتركته؛ أي أنه يصبح تاريخيا “بطريقة إبداعية” و ” لفظ التاريخية لا يقتصر على الإشارة إلى اعتماد الإنسان على التاريخ في فهم ذاته وتأويلها، وإلى لا تناهيه في تحديد ماهيته تاريخيا، بل يشير أيضا إلى استحالة الفكاك من التاريخ، وإلى الزمانية الصميمة لكل فهم[22]. وتبعا لهذا يبدو أن دلتاي حاول تطوير الهرمينوطيقا عبر إقحامها في مجال إبستمولوجي دقيق وجعلها منهجا مخصوصا لعلم التاريخ وعلوم الفكر عامة. ورغم أن أفكاره الهرمينوطيقية بقيت مجزأة وغير مكتملة فإنها استطاعت أن تحقق خطوة كبيرة للهرمينوطيقا بمواجهتها لتحدي التاريخية؛ إذ جعلت من الانتقال من منهجية للفهم، إلى منظور أكثر كلية وشمولية، أمرا ضروريا. ليتحول بذلك موضوع الهرمينوطيقا من مجرد البحث عن المعنى في النص إلى إثارة قضية الفهم وتحديد منهاجه وشروطه[23]. لذا يمكن القول إن القضايا التي طرحها دلتاي جعلت الهرمينوطيقا الحديثة منفتحة على آفاق جديدة بحيث خرجت بها من ضيق “المعيارية” التي رافقت الهرمنوطيقا القديمة والكلاسيكية إلى سعة الشمولية والعلمية والموضوعية “ليتحرر المشروع التأويلي ومعه الإنسان من سلطة الأصل المتعالي. فبدل الحديث عن تاريخ التأويلات وتسلطها على رؤية الكائن وجعله يتناهى إبداعيا إلى مجرد ماهية تاريخية ترجى استعادتها، بدل ذلك يتم إشاعة فكرة دينامية الفهم كإجراء منهجي في يد الإنسان ليحرر ذاته من أوهام التاريخ معيدا تشكيل أشياء الماضي وكل ما له صلة بإرث الإنسان الأول بطريقة مغايرة، يتحول معها التاريخ من مجرد وقائع وأحداث إلى كتابة إبداعية تصل القريب بالبعيد وتعطف الحاضر على الماضي”[24]. وبهذا فقد حقق دلتاي –على الأقل- هدفين أساسيين في مشروعه الهرمونيطيقي؛ يتمثل أولهما في تركيز مسألة التأويل على شيء له وضع ثابت وموضوعي. الأمر الذي جعل الدراسات الإنسانية تطمح إلى بلوغ معرفة ذات “صواب” موضوعي، بالنظر إلى كون موضوعها ثابتا إلى حد ما. ويتجلى الأمر الثاني في أن هذا الموضوع يحتم انتهاج مسالك تاريخية للفهم. إذ ” يتعذر أن يحصل الفهم إلا من خلال الإحالة على الحياة ذاتها بكل ما تتصف به من تاريخية وزمانية”[25]. وكما هو واضح فإن كلا الهدفين موصولان بالنزوع إلى جعل الهرمينوطيقا منهجا للعلوم الإنسانية، بحكم أن الهم الكبير الذي شغل دلتاي هو التأسيس الإبستمولوجي لعلوم الإنسان من خلال “نقد العقل التاريخي”[26].
2-4- غادمر وتأسيس نسبية الفهم:
لقد سار غادمر على خطى هايدجر من جهة عمل على نقد المنحى التقليدي للهرمينوطيقا الباحثة عن المنهج، مؤكدا على أنه يتعين رسم مسار مغاير يتناول أساسا عملية الفهم في حد ذاتها، و كذا مساراتها وملابساتها التاريخية. لذا نجده “يؤكد على ضرورة تجاوز المناهج لتحليل عملية الفهم نفسها في فعالياتها وحيثياتها التاريخية. مادامت كل المناهج – بما فيها العلمية – تتأسس على التفكير التأويلي”[27]. وعليه فإن المنطلق الأساس في المشروع الهرمينوطيقي عند غادمر يتمثل في كون أي نص هو في جوهره مضمون معرفي وليس شكلا جماليا مجردا. إلا أن تلك المعرفة تبقى- في نظره- بعيدة عن التصور الرومانسي القاضي بأن النص كاشف عن التجربة الحياتية أو النفسية للمؤلف (المبدع)، مما يعطي للنص استقلاليته الخاصة ووجوده الفريد اللذين بهما يتميز وينفصل عن نفسية المبدع.
ولعل ما يحقق استقلالية النص – وفق هذا التصور – هو فعل الكتابة؛ إذ بها “يستقل النص عن كل العناصر النفسية التي تولد عنها، ويصير بذلك حاملا لحقيقته ولتجربته المعرفية الخاصة التي يفصح عنها من خلال شكله الموضوعي الثابت”[28]. وبهذا يحوز النص القدرة على امتلاك معنى بعيد عن مبدعه فيحرر أفق المعنى من قصد المؤلف. إلا أنه في الآن ذاته تنفتح آفاق جديدة ومستمرة لفهم النص وتنويع قراءاته دونما وقوع في القراءة النمطية المعيارية. فالمعنى عند غادمر ليس حقيقة تاريخية تنتمي إلى الماضى يمكن استخلاصها من خلال البحث عنها، طالما أن المرء يفهم ضمن سياقه التاريخي وتجربته الخاصة ومعارفه المسبقة. ولأجل ذلك يتحدث غادمر عن نوعين من الأفق: أفق الماضي وأفق الحاضر، وبالتالي يقلب العملية التأويلية رأسا على عقب، وخاصة عندما يصر على أن المتاح هو نقل أفق الماضي إلى الحاضر وفهمه ضمن المعطى الراهن. الأمر الذي جعله يقف عكس كل التوجهات الهرمينوطيقية التي تروم إدراك المعنى وهو في سياق الماضي، فاتحا المجال أمام المؤول ليساهم في “صناعة المعنى” بجعل الماضي معاصرا للحاضر. ولا شك أن هذه المعاصرة التي يقتضيها فهم النص إنما تعني فتح الباب أمام النوازع والأحكام المسبقة والتجارب الحاضرة. من حيث هي أمور تؤسس – حسب غادمر – الموقف الوجودي الراهن الذي ينطلق منه القارئ لفهم الماضي والحاضر معا[29].
واضح أن المأزق الذي يوقع فيه تصور غادامر لفهم النص بتأكيده على أن المعنى الحقيقي للنص هو ما يمنحه المؤول له بحسب تجربته الحاضرة، وأن النص فاقد لمعنى في الماضي، هو النظر إلى النصوص باعتبارها قابلة للمعرفة وليست حاملة لها. لأن “اللحظة التي ينفصل فيها النص عن مبدعه تجعله يفقد حينها معيارية الفهم المحدد، وهي السمة التي تجعل النص يتحرك بمعان غير متناهية بحسب الآفاق التي تطل عليه. وبهذا تصبح الهرمينوطيقا عند غادمر تأسيسا لنسبة الفهم طالما كان الفهم هو نتاج أفق المؤول وتجربته الراهنة، فيتغير المعني باستمرار، من جيل إلى جيل، ومن عصر إلى آخر”[30].
- الهرمينوطيقا في المجال التداولي الإسلامي:بين القبول والرد.
شكلت الهرمينوطيقا بمنطلقاتها وخصائصها وأهدافها التي توقفنا عند أبرز معالمها فتحا جديدا في نطاق الفكر الحديث بشكل عام، وفي مجال قراءة النص الديني الإسلامي خاصة، لذا كان من البديهي أن تتشكل إزاء هذا المعطى الجديد مواقف متباينة تراوحت بين التأييد والرفض. فمن جهة ذهب البعض إلى أن الهرمينوطيقا هي السبيل الوحيد لفهم النص. من دون الالتفات إلى التغيرات الكبيرة التي لحقت المصطلح من جهة، والخلافات الجذرية بين مفكري الغرب تجاه العلم الموصول به من جهة أخرى . فطفق هؤلاء يطبقون رؤى بعض المفكرين ومعتقداتهم بخصوص الهرمينوطيقا على سبيل الإسقاط والتعسف دونما مساءلة ولا نقد، اعتقادا منهم أن النظرية الهرمينوطيقية تفتح الطريق أمام تأسيس جديد للمعنى القرآني وتمكن من تحقيق قراءة حداثية له بعيدا عن الإنتاج التفسيري الموروث، كما يدعي المحتفون بالفلسفة الهرمينوطيقية، الناسجون على منوالها.
3-1- منزع الاتباع والتأييد:
يمثله – من ضمن من يمثلونه- نصر حامد أبو زيد الذي يقول بشأن هرمينوطيقا غادمر: “تعد الهرمينوطيقا الجدلية عند غادمر بعد تعديلها من خلال منظور جدلي مادي، نقطة بدء أصيلة للنظر في علاقة المفسر بالنص، لا في النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسب، بل في إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى الآن. لنرى كيف اختلفت الرؤى ومدى تأثير رؤية كل عصر – من خلال ظروفه – للنص القرآني. ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف الاتجاهات المعاصرة في تفسير النص القرآني، ونرى دلالة تعدد التفسيرات على موقف المفسر من واقعه المعاصر أيا كان ادعاء الموضوعية الذي يدعيه هذا المفسر أو ذاك”[31]. ويكاد لا يختلف تصور أبي زيد أعلاه عن تصور المفكر الإيراني عبد الكريم سروش الذي يضع حدا فاصلا بين “الدين” الثابت السرمدي، وما يسميه “المعرفة الدينية” التي هي متغيرة متحولة عبر الزمان والأفق التاريخي والفكري؛ أي “باعتبارها تتطور بالضرورة وباستمرار. الأمر الذي يفرض على المسلمين أن يعيدوا بناء تأويلاتهم الدينية وفق فهمهم المتغير للعالم”[32]. من منطلق أن المعرفة الدينية جهد إنساني لفهم الشريعة، مضبوط ومنهجي وجمعي ومتحرك. ودين كل واحد هو عين فهمه للشريعة، أما الشريعة الخالصة فلا وجود لها إلا لدى الشارع عز وجل[33].
وغير خاف أن المحصول المتوقع من الممارسة التأويلية كما يؤسس لها الرجلان أعلاه (ومن يدور في فلكهما) في واقع النص القرآني هي معرفة دينية نسبية ومتحركة بشكل لا يؤمن (بفتح الميم) أن تكون هناك ملامح ذات تصور ثابت للإسلام، بل ليمكن أن ينظر إلى القرآن على أنه “نص إنساني” كما يستشف من قول نصر حامد أبي زيد الآتي:” إن القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه، لكنه من حيث يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهوما يفقد صفة الثبات. إنه يتحرك وتتعدد دلالاته. إن الثبات من صفات المطلق المقدس، أما الإنساني فهو نسبي متغير. والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه. لكن يصبح مفهوما بالنسبي والمتغير؛ أي من جهة الإنسان ويتحول إلى نص إنساني (يتأنسن). ومن الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شيئا إلا ما ذكره النص عليها، ونفهمه بالضرورة من زاوية الإنسان المتغير والنسبي. والنص منذ لحظة نزوله الأولى –أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي- تحول من كونه نصا إلهيا وصار فهما (نصا إنسانيا) لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل”[34].
3-2- منزع الرفض والرد:
في مقابل الموقف “الإيجابي”-إذا صح التعبير- من الهرمينوطيقا الغربية ثمة فئة من المفكرين المسلمين تنكر دور مباحث الهرمينوطيقا في الفهم المنظم للآيات بالنظر لطبيعة منشأ هذا “الفرع المعرفي” الذي له انتماؤه الثقافي كحاضن طبيعي لمضمونه الدلالي، كما له منطلقاته ودوافعه الخاصة، إذ تعتقد أن العوامل الآتية هي سبب تبلور الهرمينوطيقا[35]:
أ- عدم انسجام آيات الكتاب المقدس (الإنجيل والتوراة) مع العقل والبراهين العقلية، كالآيات التي تشير إلى “جسمانية” الله، أو تلك التي تتحدث عن سكر النبي نوح عليه السلام، وما إلى ذلك.
ب- عدم انسجام بعض الآيات مع بعضها الآخر، كالآيات التي تتحدث عن نسب عيسى عليه السلام؛ فجده في إنجيل متى يعقوب (ع)، بينما ورد في إنجيل لوقا أنه ينحدر من صلب هانئ.
ج- عدم انسجام جملة من آيات العهدين القديم والجديد مع معطيات ومقتضيات العلم (اشتمالها على حيز كبير من الأساطير).
د- انعدام الثقة في القراءة الوحيدة للإنجيل بالنظر إلى تعدد الأناجيل من جهة، واضطراب مضامينها من إنجيل إلى آخر من جهة أخرى.
فعلى ضوء البحث في المنشأ الخاص للهرمينوطيقا إذن، استنتج هذا التيار عدم جدوى مباحثها في فهم الآيات القرآنية، لأن القرآن في منأى عن هذه النواقص والمشاكل، ومن ثمة لا يمكن مقارنة هذه المباحث، بأي وجه من الوجوه، بقضايا التفسير والتأويل بالصورة التي وظفت بها في ساحة الدراسات الإسلامية. يقول الإدريسي أبو زيد –مثلا- في هذا الصدد:”القراءات الجديدة، التي هي في الأصل ثقافة علمية غربية انطلقت من قراءة النص المقدس منذ عصر النهضة أواسط القرن السادس عشر ثم انتقلت منه إلى نصوص أدبية وفكرية وتراثية يونانية وإغريقية، القاسم المشترك بينها(القراءات) أنها قامت على أساس اضطراب النصوص، أي بشريتها، وأن الإنجيل والتوراة قد دونتا بيد إنسانية. وما تبقى من النصوص فهو أصلا منسوب إلى أصحابه من بني البشر. ولهذا فإن هذه المناهج سواء منها الهرمينوطيقي الفينومينولوجي أو التفكيكي كلها مناهج تنطلق من تطبيق العلوم الإنسانية على النصوص الدينية نازعة عنها القدسية، ومؤمنة بنسبية المعنى، وشاكة في موثوقية التدوين، ومعطية مجالا أوسع للتأويل، ودورا أكبر للقارئ والشارح في إعادة إنتاج النص. بعبارة أخرى، يصبح النص ذا مصدر بشري وسياق بشري ومآل بشري. مما جعل هذه المناهج – وخاصة المنهج الهرمينوطيقي – أكثر جرأة في نزع المعنى وفي تحطيم السياق وفي تفكيك العلاقات القائمة بين العبارات، وفي التأويل البعيد المغرض لقلب النوايا وعكس المقاصد، والتي هي طرق ملتوية لإنتاج معنى جديد في سياق جديد لا علاقة له البتة بالسياق الذي أنتج فيه النص معناه الأول[36].
3-3- الرؤية الانتقادية التوفيقية:
مهما يكن من أمر هذا الموقف أو ذاك فإن المطلوب، من الناحية المعرفية، ليس رفض الهرمينوطيقا جملة وتفصيلا وإقصائها من المجال التداولي الإسلامي بحجة نشأة المصطلح في فضاء معرفي له خصوصيات مغايرة لتلك التي تميز نطاق الثقافة الإسلامية، ولا قبوله كما هو في أصله بحمولاته المعرفية والإديولوجية والثقافية، لأن عدم الإلمام بالأطر الإبستيمية التي تحتضن المفهوم (الهرمينوطيقا) في منشئه الأصل، وغياب الوعي بمرجعياته ووضعه في الحقل النظري الدقيق كل ذلك من شأنه أن يولد الالتباس والإرباك في التعامل معه فهما وممارسة.
لذا فإن الإدراك الجيد للإطار المرجعي والمعرفي للمفهوم يمثل ضرورة إبستمولوجية تؤمن (بتشديد الميم) حسن التوظيف، وتوفر من الشروط والحدود ما ينأى عن ضبابية الرؤية وسوء الفهم، وضيق الأفق. فالمسألة تتجاوز فيما نحن فيه قضية المصطلح في ذاته إلى قضية أشمل وأعمق تتصل ببنية الثقافة ومتانة أنظمتها وأنساقها النظرية والمعرفية ومدى قدرة أهلها على تأصيل كل ما هو دخيل من مفاهيم ونظريات ومناهج[37].
وعلى هذا الأساس فإن اعتبار الهرمينوطيقا “قاعدة أنطولوجية للفهم الموضوعي” مع شلايرماخر مثلا، أو كونها “حوارا بين تجربة النص وتجربة المتلقي” عند دلتاي، أو عدها “اكتشافا لما لم يقله النص” مع هايدجر، أو اقتضاؤها “ثبات معنى النص وتغير مغزاه” عند هيرش، وما إلى هذا من منطلقات الممارسة الهرمينوطيقية كما صيغت في الفكر الغربي، إن كل ذلك يقتضي – عند محاولة قراءة النص القرآني في ضوئه أو استنادا إلى ما يتيحه من وسائل وإمكانات للفهم والتأويل- قدرا من الحذر المنهجي والمعرفي تجنبا للتقليد الناسخ والتنزيل العشوائي للإنتاج الفكري الأجنبي. ومن الطبيعي ألا “تشذ المناهج الغربية -خاصة المنهج الهرمينوطيقي- عن هذا الوضع. فقد نشأت وترعرعت في بيئة متطلعة إلى كسر شوكة الوصاية الكنسية، وتشبعت بهاجس فكري نزاع إلى تفكيك النصوص الكتابية ونقدها. ومن هنا تلوح محاذير اجتلاب هذه المناهج بنصها وفصها إلى ساحة الدرس القرآني، إذ سيؤول هذا الاجتلاب إلى تقليد الغرب في موقفه من نصوصه المقدسة التي لا تعدو أن تكون وثائق تاريخية يحيفها التحريف والتبديل، ومن ثم تنزيل هذه المناهج على النص القرآني ببعدها الغربي”[38].
ولعل من المآزق المنهجية التي وقعت فيها القراءات المعاصرة للنص القرآني من خلال تطبيق الوسائل الغربية كما هي ما يأتي:
- المماثلة بين الموروث الإسلامي (قرآنا وسنة)، بخصائصه المعروفة، وبين الموروث التوراتي والإنجيلي الذي تخلف عن مواكبة العصور اللاحقة في الغرب بمسافات بعيدة.
- ب- تجاهل المنزع الوضعي للمناهج الغربية قاطبة، الأمر الذي قاد إلى الاصطدام مع البعد الإلهي لمصدر القرآن الكريم وحقانيته وخصائصه الإعجازية.
- التعاطي مع المناهج الغربية جميعها على أنها تؤدي إلى حقائق موثوق بها، ومن ثمة قدرتها على استنفاد إمكانات النص دلاليا ومقاصديا، وعلى الكشف عن المحجوب واللامفكر فيه[39]، حتى وإن كان متعارضا مع النص نفسه. على نحو ما حصل في دائرة الثقافة الغربية من اندفاع كلي في الهجوم على النصوص الدينية، وحرية مطلقة في تقويض أركانها ومقوماتها التي تنبني عليها.
وبالنظر إلى ذلك يبدو أن النص الديني الإسلامي غير مشمول “للعروض الحداثوية” الرامية إلى إعادة قراءة القرآن بما يناسب العصر بالصورة التي قدمها أعلام الهرمينوطيقا الحديثة. فسر الإشكالية المثارة حول إعادة قراءة النص القرآني لا تعدو كونها “مجرد عدوى أصابت بعض عقول الأمة، وحمى سرت في جسد البعض ممن عاش إشكالية الغرب حول اقتران الدين بالعلم وحاكمية الكنيسة. وكيف أن الأوروبيين تخلصوا من مرجعيات الكنيسة ورجعيتها، وانطلقوا إلى أفق العلم الرحب. ولا ريب أن تسرية الحكم إلى النص الإسلامي فيه من الإجحاف واللاموضوعية ما لا يخفى، لأن تسرية هذا الحكم يعد كاشفا إنيا عن العدوى التي يعيشها البعض لا أزمة النص الديني”[40].
إن التأمل الدقيق إذن في أهداف ومقاصد “النظرية” الهرمينوطيقية –بصرف النظر عن التباين بين تنزيلاتها- يقود إلى أن هذه النظرية تتعارض في الكثير من مقتضياتها مع المبادئ الدينية الإسلامية من عدة أوجه، وتبعا لهذا فإن العديد من تطبيقاتها على النص القرآني –كما سنوضح من خلال نموذج نصر حامد أبو زيد- تبقى في جانب كبير منها تعسفا عليه. من هذه الأوجه[41]:
- إن الفكر الإسلامي يؤمن “بمحورية المؤلف” في تفسير النص الديني لا “بمحورية المفسر” كما تدعي النظرية الهرمينوطيقية، أي أن المفسر يحاول التعرف على تعاليم السماء من خلال النص القرآني، وليس هناك من مسلك لفهم تلك المعاني والتعاليم إلا عبر النصوص الدينية.
- إن النظرية الهرمينوطيقية تقضي –من بين ما تقضي به- ب”تاريخية الفهم”؛ أي أن لكل زمان ومكان، بل لكل شخص قراءة محددة للدين وللنصوص الدينية. الأمر الذي يستلزم أن لكل عصر دين أو شريعة، أو قراءة جديدة لذلك الدين على الأقل. ولأجل ذلك لا بد أن تتغير المفاهيم والمعتقدات الدينية في كل عصر. وهذا محال لما فيه من تناف مع جوهر الدين وتصادم مع حقائقه.
- إن القول “بنسبية الحقيقة” في النظر الهرمينوطيقي يترتب عليه أنه لا مسوغ لتخطئة بعض التفسيرات والآراء، طالما أن لكل أن يفهم حسب خلفياته ومقاصده. ومن هنا فجميع القراءات والتأويلات مشروعة. وهذا محال أيضا، لأنه يقوض النص القرآني من أساسه ويذهب بالحقائق الدينية رأسا. مثلما يشرع لفوضى المعنى واضطراب الفهم. فيشيع –لا محالة- الشك المطلق واللاأدرية ويعم مبدأ عدم التناقض، وبالتالي يتزعزع الإيمان وتخلخل معه المعرفة الدينية المتوقفة على أساس معتقدات ومبادئ دينية محددة راسخة وثابتة.
- ادعاء بعض أعلام الهرمينوطيقا أن بإمكان المؤول الوصول إلى فهم “المؤلف”(موجد النص) أو يفوقه. وهذا مردود كذلك بالنظر العقلي، بحكم أن مقصد “صاحب النص” محجوب عن المؤول-كائنا من كان- فكيف يكون التفوق في فهم النص على صاحب النص نفسه؟. ومن هنا لا يستقيم تنزيل هذه المقولة على النص القرآني؛ إذ لا يمكن للمؤول –مهما أوتي من علم- أن يضاهي العلم الإلهي فضلا عن أنه يتفوق عليه. وهو إن ادعى ذلك فإنه –لا شك- محرف لدلالة النص وكابت لمقاصده[42].
4_ أنموذج هرمينوطيقي: عرض ونقد.
ليس من نافل القول التأكيد على أن القراءة التاريخية للنص القرآني تعتبر من أبرز القراءات الحداثية انتشارا وتداولا بين العديد من المفكرين العرب والمسلمين، خاصة أولائك الذين افتتنوا بالنموذج الهرمينوطيقي(التأويلي) الغربي، وتعلقوا بمسالكه ووسائله لأجل إثبات “تاريخية النص القرآني” ومحاولة إحداث قطيعة مع مناهج القدامى في تفسير وقراءة النص الديني، والابتعاد ما أمكن عن مناهج التأويل التراثي.
وعلى اعتبار أن لهذا التوجه أعلامه ومنظريه وكتابه المتعددين المعروفين فإنه يصعب – فيما نحن فيه- التوقف عند كل إنتاجاتهم في المجال، والإتيان على مجمل ومفصل أفكارهم وأطروحاتهم في الموضوع. فهذا مما لا يستوعبه بحث يتوخى الاختصار ويروم الاختزال. لذا قصرنا الاهتمام على نموذج يعد – في حيز الاعتقاد الشخصي على الأقل- متميزا، بالنظر إلى شهرته مقارنة بأقرانه في قراءة النص القرآني من جهة، وبالنظر أيضا إلى جرأته في التعاطي مع هذا النص، وما أثاره ذلك من جدال ونقاش من جهة أخرى. وليس المقصود ههنا إلا الباحث المصري المرحوم نصر حامد أبو زيد. فماذا تعني التاريخية؟ وكيف وظفها أبو زيد في قراءة النص الديني، ثم ما المزالق التي وقع فيها الرجل على هذا المستوى؟
يقول المفكر اللبناني علي حرب:” تعني التاريخية أن للأحداث والممارسات والخطابات أصلها الواقعي، وحيثياتها الزمانية والمكانية، وشروطها المادية والدنيوية، كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمصطلحات للتطور والتغير؛ أي قابليتها للتحويل والصرف وإعادة التوظيف”[43]. أما التاريخية في نظر الفرنسي آلان تورين (Alain Touraine) فهي”المقدرة التي يتمتع بها كل مجتمع في إنتاج حقله الاجتماعي والثقافي ووسطه التاريخي الخاص به “. ويضيف: “ما سوف أدعوه بالتاريخية هو الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الأنظمة الاجتماعية التي تمتلك إمكانية الحركة والفعل، والاشتغال على نفسها بالذات وذلك بوساطة مجموعة من التوجهات الثقافية والاجتماعية”[44]. وبناء على هذا فإن تاريخية النص- أي نص كان- إنما تدل على اقترانه بالواقع الزماني والمدار المكاني الذي وجد فيه، بما يجعل هذا النص لا يعدو كونه نتاجا للظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشكل في نطاقها، محصورا في بيئة تبلوره، غير مفصول عن دواعي وأسباب تكونه. كعدم انفصال العلة عن المعلول. فحيثما دارت التاريخية دارت عللها وموجبات وجودها[45].
ضمن هذا الأفق العام، عندما نعود إلى نصر حامد نجد أن رؤيته حول تاريخية القرآن إنما تتحدد في بلوغ معرفة تاريخية وعلمية بالنصوص الدينية، وما يقتضيه ذلك من نظر إلى طبيعة القرآن وماهيته من حيث هو نص لغوي ومتن تاريخي بشري، وواضح أن “البحث عن هكذا معرفة يستلزم نزاعا وجدالا مع النظرة التقليدية (التوجه الإديولوجي) الرائجة في قراءة علوم القرآن وعلوم الحديث. والتي تستلزم بدورها إعادة بلورة، وصياغة قراءة جديدة باحثة في علوم القرآن. والتي سيتقرر في نهايتها أن مفهوم النص الديني لا بد أن يبنى على القول بتاريخية هذا المحصول الثقافي”[46]. فحسب نصر حامد إن أحد أهم المداخل للوصول إلى الوعي العلمي والتاريخي للنصوص الدينية يتمثل في الوقوف بوجه الرأي القائل إن الله هو الملقي والمتكلم للنصوص الدينية، وإن هذا النص متلبس بلباس القداسة وبثوب المتافيزيقا. والتأكيد على الرأي المقابل القاضي بأن لهذا النص بعدا تاريخيا وبشريا وثقافيا، ويجب أن نتوجه إلى الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي عند استنطاق مفهومه[47].
ومن البين أن تشديد أبو زيد على البعد التاريخي للنصوص الدينية، ومهاجمته أصحاب المنطق الديني التقليدي من جهة إهمالهم – وفق تصوره- الجانب التاريخي للوحي، راجع إلى فهم مخصوص لهذا البعد التاريخي، يتمثل في إيجاد رؤية تاريخية علمية للنصوص الدينية تتعدى البحث عن الحقائق التاريخية والحوادث والاتفاقات التي حدثت في عصر نزول الوحي (كما يحصل في مباحث علم التاريخ)، إلى الاعتماد على المعطيات المعرفية التي تتيحها فلسفة اللغات تحديدا، وبالأخص تلك التي تتناول قراءة النصوص الدينية[48]. يقول أبو زيد –في هذا الصدد- مقارنا بين نظرته التاريخية للنصوص ونظرة “ذوي الفكر الديني التقليدي” غير التاريخية:” إذا كان الفكر الديني يجعل قائل النصوص – الله– محور اهتمامه ونقطة انطلاقه، فإننا نجعل المتلقي-الإنسان- بكل ما يحيط به من واقع تاريخي واجتماعي، هو نقطة البدء والمعاد. إن معضلة الفكر الديني أنه يبدأ من تصورات عقائدية مذهبية عن الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية وعلاقة كل منهما بالأخرى. ثم يتناول النصوص الدينية جاعلا إياها تنطق بتلك التصورات والعقائد. وبعبارة أخرى، نجد المعنى مفروضا على النصوص من خارجها”[49]. وبالتالي فهو يسعى إلى نقل مركز اشتغال التأويل من خارج النص القرآني إلى داخله استنادا إلى ما يسميه ب”التأويلية الحية أو المنفتحة” التي تنطلق من حقيقة أن الاختلافات الإمبريقية في المعنى الديني جزء من طبيعتنا الإنسانية القائمة على الاختلاف في معنى الحياة عموما. من هنا – حسب نصر حامد- ف”السعي إلى تأسيس تأويلية حية مفتوحة، ضدا للتأويلات السلطوية والكليانية، ينبني على حقيقة فحواها أن تأويل القرآن هو في جوهره سعي لصياغة معنى الحياة. وإذا كنا حقا جادين في سعينا لتحرير الفكر الديني من سلطة القهر والقوة؛ سياسية كانت أم اجتماعية أم دينية، من أجل إعادة الحق في صياغة المعنى الديني للمؤمنين. فلا سبيل أمامنا إلا محاولة بلورة منهجية تأويلية تقبل تأويل غيره وتبنى عليه أو تعارضه”[50].
ولا شك أن طرح نصر حامد بخصوص “تاريخية النص القرآني”؛ من حيث هي إحدى أهم المقولات التي تستند إليها الهرمينوطيقا الفلسفية، يفضي إلى جملة من النتائج المباينة- بل المتصادمة- مع المنطق التقليدي السائد في فهم النصوص الدينية. نوجزها فيما يأتي:
أ-عدم إمكان تحقق تأويل محايد للنص: على اعتبار أن فهم النصوص متوقف في جزء كبير منه على تموقع الإنسان داخل بيئته الثقافية والاجتماعية. فإذا أمعنا النظر في النصوص والمتون الدينية، من الناحية الأنطولوجية (الوجودية)، لوجدنا أنها محكومة بالأحداث التاريخية وواقع اللغة، كما للواقع الاجتماعي والثقافي في عصر صدور وحدوث النص. وإذا نظرنا، من الزاوية الإبستيمولوجية (المعرفية) لألفينا أن تشكل الوعي بالنص محكوم أيضا بتلك العوامل المذكورة. ومن هنا – تبعا لنصر حامد- فإن دلالة النص لا تنحصر في نظام الدلالة الذي يحدد مسبقا من خلال الحوادث التاريخية والزمانية، واستنادا إلى السياق الثقافي والاجتماعي لزمن الصدور، وإنما سينفتح لزوما على آفاق مستقبلية يتوجه النص فيها إلى مخاطبين جدد في عصور جديدة، تشكل عندها “القراءة الإبداعية” للنص على أساس كشف المحددات التي ترسم دائما التأويل تبعا للبيئة الثقافية واللغة الموظفة[51].
ب-ثبات المنطوق وتغير المفهوم: بحكم أن “النصوص الدينية تأنسنت (صارت إنسانية) منذ تجسدت في التاريخ واللغة، وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محدد. إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير، فالنصوص ثابتة في المنطوق متغيرة في المفهوم”[52]. وهذا لا شك مسلك المفكر الأمريكي “هيرش” الذي يضع تقابلا بين “المعنى اللفظي”(verbal meaning) و”المغزى”(significance). الأمر الذي يفرض علينا –حسب نصر حامد- أثناء مطالعتنا للنصوص الدينية والتراثية النظر إليها من ناحيتين؛ الأولى لها علاقة بإدراك الدلالة الأصلية والتي تعد من سنخ الفهم التاريخي (قراءة تاريخية). أما الثانية فتتمثل في فهم النصوص من خلال حضورها في السياق الاجتماعي والثقافي المعاصر؛ أي محاولة إعادة قراءة وفهم النصوص لا على أساس الواقع الأصلي في زمن نزول النص، بل على ضوء الواقع الاجتماعي القائم[53].
ومؤدى هذا أن النص القرآني إذا توجه بمنطوقه الثابت إلى المخاطبين الذين نزل فيهم وتشكل في إطار بيئتهم الثقافية، يكون حبيس هذا السياق التاريخي المحدد. أما مفهومه فمتغير متبدل تبعا لتغير العصور وتبدل الأمكنة، وتبعا لاختلاف أفق المتلقين له وتباين تجاربهم. وهو لهذا لن يصير إلا وعاء فارغا قابلا لما يملأ به من كل قراءة، وفضاء مفتوحا لما يمكن من التأويلات والاحتمالات ومراتب الدلالة[54].
ج-تنسيب الأحكام وتشتيت دلالة النص: إن إقرار نصر حامد أبو زيد بانفتاح النص القرآني وقابليته لقراءات وتفسيرات عديدة وفقا لتبدل الأزمنة والعصور واختلاف وجهات المؤول المعرفية، ووفقا أيضا لطبيعة الرؤية الحاكمة على عناصر المنهج المتبع في الاستنطاق والفهم، إن كل ذلك يجعل النص رهين أفق المؤول وتمثلاته الخاصة التي لا تنفك عن تجربته في التلقي وقدرته على “توليد” الدلالات و”صناعة” المعاني، من منطلق أن كل قارئ يخلق النص، فهو خلاق آخر يساير خلاق النص[55]. ولا شك أن “هذه التعددية في التلقي والاستقبال، وهذه الإمكانية في الفهم والتأويل تحيل على تاريخية القراءة وتزيد الأحكام تعلقا بظروفها وسياقها الزمني. ومن هنا لا يمكن حمل الآيات القرآنية على معنى مستقر ودلالة ثابتة، بله أن تدعي إمكان القبض على ناصية المطلق”[56]. وهو أمر من شأنه أن “يفرغ النص الديني من دينيته” وينزع عنه قدسيته وحقانيته اللتين بهما يعرف ك”وحي”، ويتعالى على غيره من النصوص البشرية الدنيوية.
د-أنسنة النص القرآني وانتهاك قداسته:
يصر نصر حامد في أكثر من موضع من كتابه”نقد الخطاب الديني” وكذا في”مفهوم النص” و”النص والسلطة والحقيقة” على كون النصوص الدينية ليست ،أولا وأخيرا، إلا نصوصا لغوية بما أنها تنتسب إلى نسق ثقافي مخصوص وبنية ثقافية محددة، تم إنتاجها وفقا لقوانين ذلك النسق وضوابط تلك البنية اللذين تعد اللغة النظام الدلالي المركزي فيهما. فميزة النصوص الأساسية كونها لا تنفصل عن النظام اللغوي العام للثقافة التي تحتضنها، إلا أنها من جانب آخر تخلق شفرتها الخاصة التي تساهم في إعادة ترتيب وبناء عناصر النظام الدلالي الأصلي من جديد. ومن هنا –حسب أبو زيد- فإن أصالة النصوص وتحديد درجة إبداعيتها إنما يقاسان بما تحدثه من تطور في النظام اللغوي وما تحققه نتيجة لذلك من تطور في الثقافة والواقع معا[57]. الأمر الذي يستند إليه الباحث كمبرر لتجريد النص القرآني من طابعه القدسي السماوي و”ينزل به إلى الأرض” لتساوى مع غيره من النصوص البشرية وبالتالي يصبح قابلا ليجري عليه ما يجري عليها من تحليل وتفكيك، ويخضعه لما تخضع هي له أيضا من تفسيرات وتأويلات على قدر ما تتيحه مناهج التحليل وأدوات القراءة. يقول في هذا السياق:”لعلنا الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول إن النصوص الدينية نصوص لغوية شأن أي نصوص أخرى في الثقافة، وأن أصلها الإلهي لا يعني أنها في درسها وتحليلها تحتاج إلى منهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها الإلهية الخاصة. فالقول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية بوهب بعض البشر طاقات خاصة تمكنهم من الفهم..وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم الإنسان العادي وتصبح شفرة إلهية لا تحلها إلا قوة إلهية خاصة”[58].
وكما سبق البيان – في فقرات سابقة- فإن تبني نصر حامد “القول ببشرية النصوص الدينية” بحكم انتمائها للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة (فترة إنتاجها وتشكلها) يترتب عليه بالضرورة أمران، أولهما أن هذه النصوص “نصوص تاريخية”؛ بما أن دلالاتها ومقاصدها لا تنفك عن النظام اللغوي الثقافي الذي تعد جزءا منه. وعلى هذا الأساس فإن اللغة والمحيط الثقافي الموصول بها يمثلان المرجع الأساس في التفسير والتأويل. وثانيهما أن “تاريخية الدلالة” لا تعني، بأي حال من الأحوال، تثبيت المعنى الديني عند فترة تشكل النصوص، من منطلق أن اللغة – التي هي الإطار المرجعي للتفسير والتأويل- ليست ثابتة ساكنة بل تتحرك وتتطور مع الثقافة والواقع. وحركية اللغة هاته – حسب نصر حامد- تنعكس على حركية النصوص فتنقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز[59].
ولعل ما يثير الانتباه عند صاحب “إشكاليات القراءة وآليات التأويل” أن تلك “الحركية اللغوية” وبعدها النصية وانعكاساتهما على الفهم والتأويل، كما على التشريعات والأحكام، يوظفها أيضا في معالجته لقضية “الناسخ والمنسوخ” بما هي قضية يتجلى فيها بوضوح–كما يتصور- تغير النصوص وتبدل التشريعات. فالنسخ عنده “إبدال نص بنص آخر مع بقاء النصين معا”. والأحكام الشرعية خاصة بالبشر في حركتهم داخل المجتمع، لذا لا يصح إخضاع الواقع المتغير لأحكام وتشريعات جامدة لا تتحرك ولا تتطور[60]. ولا يخفى ما في التحديد الذي يقدمه الرجل للنسخ من إجحاف وتعسف، بحكم أن النسخ لا يتعلق بالنص وإنما بالحكم الدال عليه. أما النص فهو باق سواء كان ناسخا أم منسوخا. لم يلحقه التبديل لا خلال زمن النزول ولا بعد وفاة النبي عليه السلام[61]. وإذا كان ثمة من تبرير لتعاطي نصر حامد مع النص القرآني على هذا النحو إنما هو الاقتراب ما أمكن من نقض طبيعة النص القرآني المتعالية وجعله موصولا بواقع العرب التاريخي والاجتماعي الذي “تشكل” في نطاقه؛ أي من حيث هو “نص لغوي إنساني” مرتبط بالثقافة التي تشكل خلالها وباللغة التي كتب بها. وبالتالي فهو نتاج معرفي قابل لأن يستجيب للشروط النقدية التي تخضع لها سائر الإنتاجات المعرفية الأخرى التي يبدعها البشر[62].
- التقويم التكاملي للنموذج:
لقد تبين من جملة ما عرضناه عن تصور أبو زيد – المستند إلى الهرمينوطيقا الغربية في قراءة النصوص- أن مدار الأمر عنده في التعاطي مع النص القرآني أنه “منتج ثقافي” لا يختلف، من جهة ارتباطه باللغة وتجسده فيها، عن بقية النصوص الإنسانية من تفاعل ومؤثرات. لذا –كما يقول- فإن “الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره. فالواقع أولا والواقع أخيرا. وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما إلى أسطورة”. ولا شك أن طرحا من هذا النوع ينطوي على محاذير عدة تصطدم مع جوهر النص القرآني نجملها في الملاحظات الآتية:
أولا، إن الإفراط في الاعتداد بتأثير الواقع الاجتماعي والسياق الثقافي على النص القرآني يجعل “المحورية” تنتقل من النص إلى الظروف التارييخية والثقافية والتحولات الاجتماعية، وبالتالي تغدو هاته العوامل مجملة هي الأصل المؤثر في دلالة النص، كما يصير هذا النص –لا محالة- مجرد تابع لها ومنفعل بها. وهذا مما لايتصور حدوثه مع النص القرآني. لأنه كما لا يجوز –حسب تصور نصر حامد- “إهدار الواقع لحساب النص” فكذلك لا يمكن إهدار النص لحساب الواقع. فالأديان بشكل عام “إنما جاءت لتسمو بالواقع لا أن تستسلم له”[63]. مثلما أن النصوص الدينية إنما وجدت لتضبط الواقع لا أن تنضبط هي به.
ثانيا، إن القول بوجود معنى نسبي غير ثابت للنص القرآني يحرر الطاقة التأويلية للقارئ فيتوسع إلى أبعد الحدود في معنى النص مما قد يوقعه في الانقطاع الكلي عن الدلالة الأصلية المحددة في زمن النزول. وتبعا لذلك يجوز للقارئ أن يعيد صياغة معنى النص على أساس المستجدات االمعرفية والاجتماعية الحاصلة، على نحو يدخل (بضم الياء) في فوضى التأويلات، ويوقع في تيه الإسقاطات التي لا يتحملها النص القرآني ولا تنسجم مع طبيعته.
ثالثا، إن “خطة التأريخ” التي توسل بها أبو زيد تستهدف بالأساس رفع عائق “الحكمية” المتمثل في اعتقاد أن القرآن جاء بأحكام أزلية ثابتة[64]. والمسلك المؤدي إلى ذلك هو ربط آيات الأحكام بسياقها التاريخي ووقائع نزولها على نحو يجعل النص محصورا في نطاق أسبابه الخاصة مقتصرا عليها، ولا يتيح تعدية حكمه في أفق المستقبل إلى وقائع مشابهة في المناط والعلية[65]، وهذا شكل من أشكال قتل النص وإهدار لحركيته المتجددة التي تناسب مختلف الأزمنة والأمكنة.
رابعا، إن دعوى “الأنسنة”(القول ببشرية النص) التي يبني عليها أبو زيد قراءته للنص القرآني تهدف- من بين ما تهدف إليه- إلى رفع عائق القداسة الذي يتمثل في اعتقاد أن القرآن كلام مقدس. والعملية المنهجية المحققة لذلك هي نقل الآيات القرآنية من وضعها الإلهي إلى الوضع البشري. بحيث ينزل من منزلة التعلق بالمطلق إلى رتبة التعلق بالنسبي. وبالتالي يتم فصل النص القرآني عن مصدره المتعالي وربطه بشكل كامل بالمتلقي البشري الذي يمارس استنطاقه للنص من خلال خلفيته المعرفية ومرجعيتة الثقافية ووضعيته الاجتماعية والسياسية، فلا يكون المحصول حينئذ إلا إبداعا لمضامين إنسانية صرفة[66]، ودلالات تعكس مقاصد القارئ أكثر مما تنطق بحقيقة النص.
خاتمة:
لقد أفضى البحث الذي توخى رصد حركية الهرمينوطيقا في السياق الغربي نشأة وتطورا، وفي السياق العربي الإسلامي استقبالا وتوظيفا، إلى جملة نتائج نلخصها على النحو الآتي:
- إن الهرمينوطيقا، من حيث هي فرع معرفي يعنى بتفسير النصوص وتأويلها، عرفت تحولا جوهريا على صعيد موضوع الاشتغال إذ انتقلت من العناية بالنصوص المقدسة تحديدا (في الماضي) إلى الاهتمام بالنصوص البشرية عامة، فيما بعد.
- إن ما يميز الهرمينوطيقا الحديثة كونها تبلورت في سياق “إشكالية الفهم المسبق” التي عكست بجلاء “عدم موضوعية الوعي الإنساني المعاصر”. ومن ثمة فبدل أن تبقى متمركزة حول تفسير نصوص مخصوصة أخذت شكل علم يعنى ب”عملية الفهم في حد ذاتها” مما ترتب عليه الانتقال من المؤلف والنص إلى القارئ وكيفية الفهم.
- إن الهرمينوطيقا في المجال التداولي الإسلامي نالت ما يلزم من “التهويل والتهوين”، أو لنقل التمجيد والاحتقار. فقد تم الاحتفاء بها من قبل ثلة من المفكرين المسلمين الذين رأوا فيها وسيلة تساعد على القيام بقراءات تجديدية للنص القرآني كمدخل لتحديث الفكر والواقع. كما تم –بالمقابل- نبذها من لدن فئة أخرى باعتبار منطلقاتها (الهرمينوطيقا) الغربية ومرجعياتها غير الإسلامية، وبالتالي فتطبيقاتها على قراءة النص القرآني تسهم في محو خصوصياته أكثر مما تساعد على فهمه وتأويله. وكلا الرؤيتين غير سليمتين من جانب، ومحتاجتان إلى مراجعة وتعديل من جانب آخر، كما تبين.
- إن القراءة الهرمينوطيقية التي قام بها بعض المفكرين المسلمين من أمثال نصر حامد أبو زيد للنص القرآني تبدو في بعدها العام تقليدا واضحا ونسخا صريحا لما أنتجه الفكر الغربي؛ أي أن محصول الجهد التأويلي – في غالبيته- على هذا المستوى ليس إلا إسقاطا للممارسة الهرمينوطيقية كما تجلت في السياق الغربي، وإعادة إنتاج لتشغيل أدواته المنهجية التي أوجدها الغرب – انسجاما مع ظروفه الثقافية والاجتماعية والتاريخية وغيرها- لقراءة نصوصه التراثية ومتونه الدينية.
- إن الحاجة – في ظل الواقع الراهن- لماسة (بتشديد السين) إلى تأسيس “هرمينوطيقا عربية إسلامية” حديثة وفق مشروع علمي محكم يحقق قدرا من التوازن والتكامل بين استحضار الموروث الإسلامي التفسيري والتأويلي، واستيعابه على سبيل التحوير والتحويل، من جهة، والاستفادة مما استجد في مجال الإبداع العصري المعرفي والمنهجي تحديدا، من جهة أخرى. الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى قراءة متجددة للنص القرآني وإلى فهم مبدع له دونما مس بخصوصيته ولا انتهاك لقدسيته، أو تشكيك في حقانيته وإلغاء لحكميته، ولا مماثلة بينه وبين ما سواه من النصوص البشرية، وما شابه هذا مما تقتضيه “أسلمة الهرمينوطيقا” كما سنوضح في بحث لاحق بإذن الله تعالى، الذي سنضع من خلاله لبنات هذا المشروع ونحدد معالمه الأساسية.
[1] – التأويلية(الهرمينوطيقا). دراسة منشورة على موقع: www.aldhiaa.com
[2] – الموقع السابق.
[3] – سعيد توفيق. في ماهية اللغة وفلسفة التأويل. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 2002. ص: 123.
[4] – الحبيب بوعبد الله. “مفهوم الهرمينوطيقا: الأصول الغربية والثقافة العربية”. مجلة الفكر العربي المعاصر. العدد 141-142. 2007. ص:111
[5] – عز العرب الحكيم بناني.”الهرمينوطيقا والفلسفة”. ضمن: كتاب آفاق هرمينوطيقية. منشورات دار ما بعد الحداثة.المغرب. 2007.ص:10
[6] -Jean Pépin. L’hermeunitique ancienne. Seuil. Paris. 1975. P :83
[7] – الحبيب بوعبد الله. “مفهوم الهرمينوطيقا”. مرجع مذكور. ص: 112
[8] – الحكيم بناني. الهرمينوطيقا والفلسفة. مرجع سابق. ص: 11
[9] – عبد السلام حيمر. الإصلاح، الموت، الجقيقة. منشورات جامعة مولاي إسماعيل. مكناس. المغرب. 2003. ص: 184
[10] – مجموعة من المؤلفين. التأويل والهرمينوطيقا: دراسات في آليات القراءة والتفسير. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. لبنان. بيروت. 2011. ص: 45.
[11] – التأويل والهرمينوطيقا. مرجع سابق. ص: 49.
[12] -Peter Szondi. L’herméneutique de schleiermacher. In poétique. N.2. éd. Seuil. Paris. 1970. P : 142
[13] – المرجع السابق. ص: 49.
[14] -H.G.Gadamer. vérité et méthode. Seuil. Paris. 1976. P : 128
[15] – يراجع في هذا الصدد الحبيب بوعبد الله. “مفهوم الهرمنوطيقا”. مرجع مذكور. ص: 115 وما بعدها.
[16] – مختار الفجاري. الفكر العربي الإسلامي: من تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم. عالم الكتب الحديث. الأردن. 2009. ص: 3.
[17] – التأويل والهرمينوطيقا. مرجع سابق. ص: 51
[18] – مجموعة من الباحثين. دراسات في تفسير النص القرآني: أبحاث في مناهج التفسير. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. بيروت. 2007. ص: 41-42.
[19] – المرجع السابق. ص: 43.
[20] – نفسه. ص: 52.
[21] -Grondin Jean. L’universalité de l’herméneutique. Paris. 1943. (Essais philosophique). P : 135
[22] – عادل مصطفى. فهم الفهم: مدخل إلى الهرمينوطيقا. دار رؤية للنشر والتوزيع. 2007. ص: 135.
[23]– الحبيب بوعبد الله. “مفهوم الهرمينوطيقا”. مرجع سابق. ص: 117.
[24] – عبد الغني بارة. الهرمينوطيقا والفلسفة: نحو مشروع عقل تأويلي. الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف. 2008. ص: 195
[25] – عادل مصطفى. فهم الفهم. مرجع مذكور. ص: 152
[26]-Jean Grondin. L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine. Paris. Librairie philosophique. 1993. P :155
[27] – شرف عبد الكريم. من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة. الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف. بيروت – الجزائر. 2007. ص: 24.
[28] – المرجع السابق. ص: 38.
[29] – معتصم السيد أحمد.”الهرمينوطيقا: جذور المصطلح ودلالات المعنى”. مجلة البصائر. العدد 50. 2012. موقع على شبكة الأنترنت: www.albasaer.org
[30] – المرجع السابق.
[31] – نصر حامد أبو زيد. إشكاليات القراءة وآليات التأويل. المركز الثقافي العربي.ط. 6. 2001. ص: 49.
[32] – ولاء وكيلي. الحوار حول الدين والسياسة في إيران: الفكر السياسي لعبد الكريم سروش. ترجمة حسن أوريد. دار الفنك. الدارالبيضاء. المغرب. 1999. ص: 33.
[33] – عبد الكريم سروش.القبض والبسط في الشريعة. ترجمة: دلال عباس. دار الجديد. منتدى الحوار العربي الإيراني. لبنان. بيروت. 2002. ص: 30.
[34] – نصر حامد أبو زيد. نقد الخطاب الديني. سينا للنشر. القاهرة. مصر. ط.1. 1992. ص: 93.
[35] – دراسات في تفسير النص القرآني. مرجع مذكور. ص: 33-34.
www.tafsir.net .- الإدريسي أبو زيد. “الاتجاه الهرمنيوطيقي وأثره في الدراسات القرآنية”. على الموقع الآتي[36]
[37] – الحبيب بوعبد الله. “مفهوم الهرمينوطيقا”. مرجع مذكور. ص: 110.
[38] – قطب الريسوني. النص القرآني: من تهافت القراءة إلى أفق التدبر. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية. ط.2010. ص: 403.
[39] – نفسه. ص: 402.
[40] – منطق فهم القرآن: الأسس المنهجية للتفسير والتأويل. أبحاث السيد كمال الحيدري. بقلم طلال الحسن. ج1. دار فراقد. 2012. ص: 19.
[41] – التأويلية(الهرمنوطيقا).مرجع سابق. على موقع:www.aldhiaa.com
[42] – قطب الريسوني. النص القرآني. مرجع مذكور. ص:405.
[43] – علي حرب. نقد النص. المركز الثقافي العربي. 1998. ص: 65.
[44] – محمد أركون. الفكر الإسلامي: قراءة علمية. ترجمة هاشم صالح. مركز الإنماء القومي، بيروت. والمركز الثقافي العربي، الدر البيضاء-بيروت. ط2. 1996.ص: 116.
[45] – قطب الريسوني. النص القرآني. مرجع سابق. ص: 210.
[46] – أحمد واعظي. “تاريخية القرآن عند نصر حامد أبي زيد”. ترجمة: حسين صفي الدين. مجلة المحجة. العدد 25. 2012. ص: 71.
[47] – نصر حامد أبو زيد. مفهوم النص. المركز الثقافي العربي. بيروت. 1994. ص:10-12.
[48] – أحمد واعظي. مرجع مذكور. ص: 73. ثم نصر حامد أبو زيد. نقد الخطاب الديني. سينا للنشر. 1994. ص: 188 وما بعدها.
[49] – نصر حامد أبو زيد. نقد الخطاب الديني. مرجع سابق. ص: 189-190.
[50] – نصر حامد أبو زيد. التجديد والتحريم والتأويل. المركز الثقافي العربي. بيروت-الدار البيضاء. ط.1. 2010. ص:215.
[51] – نصر حامد أبو زيد. نقد الخطاب الديني. مرجع مذكور. ص: 115. ثم أحمد واعظي. مرجع مذكور. ص. 76 وما بعدها.
[52] – المرجع نفسه. ص: 118.
[53] – أحمد واعظي. مرجع سابق. ص: 74. وللتوسع ينظر: نصر حامد أبو زيد. النص والسلطة والحقيقة. المركز الثقافي العربي. ط.4. 2000 . ص: 159 وما يليها.
[54] – قطب الريسوني. النص القرآني. مرجع سابق. ص: 288-289.
[55] – نصر حامد أبو زيد. إشكاليات القراءة وآليات التأويل. مرجع سابق. ص: 241.
[56] – قطب الريسوني. النص القرآني. مرجع مذكور. ص: 289.
[57] – نصر حامد أبو زيد. نقد الخطاب الديني. مرجع مذكور. ص: 204-205.
[58] – نفسه. ص: 208-209.
[59] – نفسه. ص: 210.
[60] – نصر حامد أبو زيد. مفهوم النص. مرجع سابق. ص: 121.
[61] – لمزيد تفصيل في هذه النقطة يحسن الرجوع إلى فريدة زمرد. أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيد. مطبعة آنفو-برانت. فاس. المغرب. 2005. ص: 72 وما يليها.
[62] – للتوسع يراجع علي حرب. الاستلاب والارتداد: الإسلام بين روجيه غارودي ونصر حامد أبو زيد. المركز الثقافي العربي. 1997. ص: 101 وما بعدها.
[63] – جمال البنا. تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين. دار الشروق. القاهرة. مصر. 2008 . ص:242.
[64] – طه عبد الرحمن. روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. المركز الثقافي العربي. 2006. ص: 184.
[65] – قطب الريسوني. النص القرآني. مرجع مذكور. 285.
[66] – طه عبد الرحمن. روح الحداثة. مرجع مذكور. ص: 178-181.




















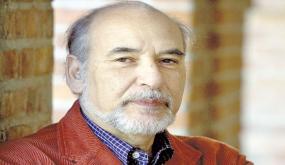

الخامس غفيرمنذ 6 أشهر
بوركت جهودكم فضيلة الدكتور العياشي، رحلة فلسفية و رؤية متبصرة لحقيقة الهيرمينوطيقا و علاقتها بموضوع النص الديني، ما أحوجنا لمثل هذه القراءات النقدية و الموضوعية لكل ما يتم استقباله من قضايا معرفية ذات المنزع الغربي.
شكرا جزيلا لكم سيدي و من نجاح إلى نجاح غن شاء الله موفق و مسدد دكتورنا الغالي.