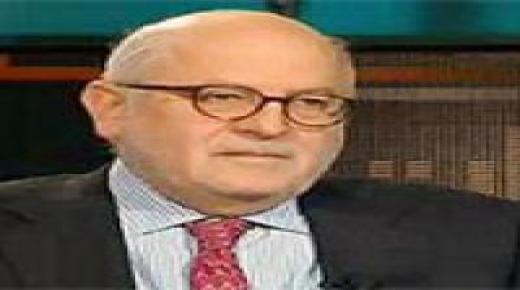نزار بولحية
كسابقتها أم أكثر سوءاً منها؟ أم أنها كانت بالفعل كارثية بأتم معنى الكلمة؟ على اختلاف التقديرات والتوصيفات، فإنه سيكون مستبعدا أن يذرف المغاربيون دمعة واحدة على سنة 2022. والتحدي الذي قد يواجهونه ليس في أن يتمكنوا من طي صفحتها فحسب، بل في أن يتخطوا رواسبها في أقرب وقت وليس ذلك بالسهل. فاللوحة تبدو مشوشة للغاية، إذ لا تزال الحدود البرية بين أكبر بلدين مغاربيين، أي الجزائر والمغرب مقفلة منذ أكثر من عقدين، وعلاقتهما الدبلوماسية مقطوعة لأزيد من عام كامل، فيما يستمر حظر عبور الطيران المدني المغربي الأجواء الجزائرية وإلى أجل غير معلوم.
التعامل الظرفي مع الأحداث لا يزال نقطة الخلل الكبرى في تفاعل الدول المغاربية مع بعضها، فالأهواء تسبق الاستراتيجيات وتحدد مسار علاقاتهم
وكأن ذلك لا يكفي، فالمغرب وتونس سحبا الصيف الماضي سفيريهما من العاصمتين، وهما الآن في شبه قطيعة. كما أن الغموض لا يزال يلف مستقبل ليبيا. وإن سألنا بعدها عن حال المغرب الكبير في 2022 فلن نتردد في القول إنه بدا متماسكا فقط في بعض المناسبات مثل مونديال قطر، لكنه مفرق في معظم الفترات. لقد قربه الرياضيون أشواطا رمزية إلى الأمام، وأعادته عقول وخيارات السياسيين خطوات فعلية إلى الوراء.
وفيما عاش الليبيون والتونسيون والجزائريون والمغاربة والموريتانيون خلال العام الذي بدأ بحزم حقائب الرحيل، أحداثا قد تختلف أو تتفاوت في درجة الخطورة والأهمية، فإن التطورات التي عرفتها المنطقة المغاربية في 2022 بددت آخر الآمال الضئيلة في أن يحصل تقارب، ولو محدود بين دولها. لقد كانت تلك السنة واحدة من أقسى وأصعب سنوات الصراعات والتصدعات التي مرّت بالمغاربيين في العقود الأخيرة، بدأت بتواصل وتعمق قطيعة دبلوماسية غريبة وغير مفهومة حصلت قبلها بعام بين الجزائر والمغرب، وانتهت بتكريس شبه قطيعة أخرى شاذة وغير مبررة أيضا بين تونس والمغرب. ولم يكن ذلك أمراً لا مناص من حدوثه. فأكثر من فرصة كانت مواتية لأن يتغير مجرى الرياح. ومع أن الاتصال الرسمي الأول الذي جرى بين المغاربة والجزائريين في سبتمبر الماضي، حين سلّم وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون، للملك محمد السادس للمشاركة في القمة العربية، التي احتضنتها الجزائر مطلع نوفمبر الماضي، تم في أجواء ملبدة وغير مبشرة بالمرة، وامتاز بالفتور والبرود، إلا أن كثيرين تطلعوا لأن تكون القمة التي حرص الجزائريون على تسميتها بقمة «لم الشمل» العربي مناسبة لإعادة ولو بعض الدفء المفقود في علاقة العاصمتين المغاربيتين. وعززت الأنباء التي ترددت حينها حول نية العاهل المغربي التحول بنفسه إلى العاصمة الجزائرية مترئسا وفد بلاده فيها من تلك التطلعات. لكن وزير خارجيته الذي سبق أن قال إن «الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر»، عاد ليؤكد بعدها في تصريح إعلامي أدلى به إلى قناة «العربية» أنه يتعذر عليه حضورها «لاعتبارات إقليمية» على حد وصفه. وكان الدليل الأكبر على أن الهوة السحيقة بين البلدين، كبرت واتسعت بشكل غير مسبوق، وأن الاتصالات بينهما خلال قمة الجزائر لم تحصل مباشرة، بل تمت فقط بواسطة طرف ثالث هو الجامعة العربية، في مشهد غير معتاد بين بلدين عربيين جارين. ولم يكن التدارك بعدها بالسهل، فالدعوة التي وجهها العاهل المغربي لاحقا إلى الرئيس الجزائري لزيارة المغرب من «أجل الحوار» بعد أن تعذر ذلك في القمة، بقيت معلقة دون رد، والحديث الذي تردد عن وجود وساطات بين الطرفين ونفاه الإعلام الجزائري باستمرار، تأكد هذه المرة ليس فقط من خلال ما قاله وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مايو الماضي، من أنه «لا وساطة مع المغرب لا أمس ولا اليوم ولا غدا»، بل بتشديد الرئيس الجزائري تبون أواخر الشهر الجاري في حديثه مع وسائل إعلام محلية على أنه «لو كانت هناك وساطة فالشعب الجزائري أولى بسماع المعلومة». غير أن الجديد الذي حملته سنة 2022 هو أن البرود الملحوظ الذي عرفته العلاقات التونسية المغربية في فترة سابقة سرعان ما تحول إلى خلاف دبلوماسي حاد بين البلدين، في أعقاب إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد في أغسطس الماضي على استقبال زعيم جبهة البوليساريو في بلاده على هامش القمة الافريقية اليابانية، في خروج واضح وصريح عن الموقف التونسي التقليدي من نزاع الصحراء. وعمليا فقد دق ذلك الاستقبال إسفينا عميقا في نعش العمل المغاربي المجمد، وجعل أمين عام الاتحاد المغاربي الذي انتهت عهدته الصيف الماضي يخرج عن صمته المزمن والطويل ليقول، إنه نصح تونس بالقيام بمبادرة صلحية إثر قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، ثم بعقد «خلوة مغاربية» بين وزراء خارجية الدول المغاربية والأمين العام للاتحاد لبحث الحل السياسي في ليبيا، قبل أن يضيف بعدها أنه شاهد «بكل أسف وألم فرصة أخرى تهدر وتغيب فيها المبادرة، بمناسبة انعقاد القمة اليابانية الافريقية الثامنة في تونس» حسبما جاء في بيانه. لكن هل كان بمقدور المغاربيين فعل شيء آخر غير البكاء على الأطلال، وإلقاء المسؤولية على غيرهم عن أي تقصير؟ إن مشكلتهم هي أنهم حتى إن انتبهوا إلى الحاجة إلى القيام بتحرك ما، فإن تصورهم له عادة ما يكون، إما بشكل جزئي ومحدود أو أنه يأتي في وقت متأخر. وبدلا من معالجة الخلافات التي تحصل بين الدول المغاربية بأقصى سرعة وتطويقها في المهد، فإنهم يفضلون عادة تركها تتطور لتكبر وتصبح السيطرة على آثارها وتداعياتها عليهم كلهم مهمة شاقة وصعبة، بل ربما حتى شبه مستحيلة. لقد حاول الرئيس التونسي الراحل بورقيبة مثلا، وفي وقت ما، أن يتوسط بين الجزائر والمغرب، لكنه سرعان ما رمى المنديل بعدها، ولم يملك الإصرار والعزيمة ليكرر المحاولة من جديد، لكن هل كان بورقيبة الذي جمعته علاقات قوية بالعاهلين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، رغم الجفاء والقطيعة التي حصلت بينه وبين الأخير، بعد اعتراف تونس باستقلال موريتانيا يدرك أن ذلك قد ينعكس يوما على تونس؟ وأن العلاقات التونسية المغربية ستتهاوى وتنحدر في وقت من الأوقات إلى الوضع الذي باتت عليه اليوم بفعل بقاء واحدة من أعقد الملفات بين الجزائر والمغرب، وهي قضية الصحراء، من دون حل؟ إن التعامل الظرفي مع الأحداث كان ولا يزال نقطة الخلل الكبرى في تفاعل الدول المغاربية مع بعضها بعضا، فالأهواء تسبق الاستراتيجيات وهي التي تحدد وبشكل كبير مسار العلاقات المغاربية المغاربية. ومع أن المغاربيين استطاعوا وإلى حد ما أن يتجاوزوا ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي والإسباني بحقهم من جرائم، فإن قدرتهم على تخطي ما قد يعتبرونها إساءات، أو حتى اعتداءات قد تكون ارتكبت في ما بينهم تبدو ضعيفة للغاية. ولأجل ذلك فإن نجاحهم في محو سنة 2022 من ذاكرتهم سيكون أكبر امتحان مصيري ينتظرهم في الشهور المقبلة.
كاتب وصحافي من تونس