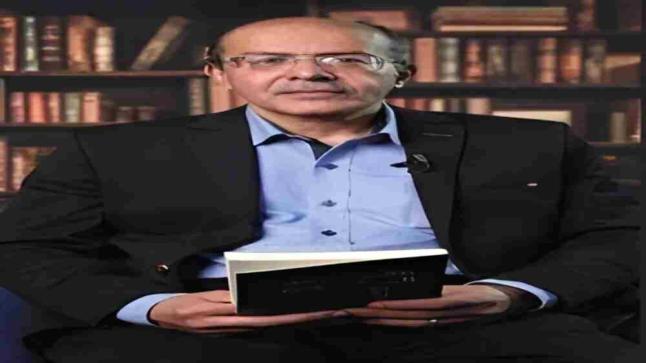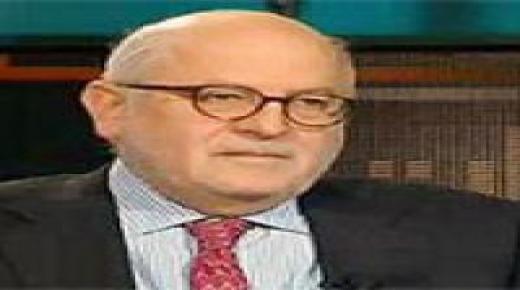إيهاب الحضري*
يمنح الصمت للمكان فرصة استعراض عضلات جمالياته. حتى المقاهى تكشف عن فتنتها بعد أن يغادرها المزعجون، ويقتصر الحضور فيها على من أجهدهم التعب!
غواية المؤثرين
السبت:
أستعين على قضاء حاجتى برسالة «واتس آب»، بدلًا من إجراء مكالمة هاتفية. الاختيار لا ينبع من كسل، بل هو بديلٌ اضطرارى للهروب من عبارات عتاب زوجتى، التى بدأتْ معدلاتها تتزايد فى الفترة الأخيرة. طلبتُ منها فى رسالتى استلام سلعة من مندوب التوصيل، كنتُ قد طلبتُها بعد أن استسلمتُ لغواية حسناءٍ على وسائل التواصل، أقنعنى الفيديو الذى بثّتْه أن الحياة شبه مستحيلة بدون المنتج الذى تُسوّقه!
مؤخرًا اكتشفتُ أننى فريسة سهلة لمروجى السلع فى الفضاء الإليكترونى، رغم أننى كنتُ أتخلص دائمًا من إلحاح المُسوّقين عبر المكالمات التليفونية، تمامًا مثلما أرد باقتضاب على شباب يدورون على المقاهى، ويحاولون إقناع مرتاديها ببضاعتهم، لكن يبدو أن المواجهة المباشرة أكثر سهولة من «ندّاهة السوشيال ميديا»، فها هو حائط مقاومتى ينهار أمام إغراء وسائل الدعاية المبتكرة.
قبل أسابيع ناقشتُ كتابًا فى معرض الكتاب، اجتذبنى عنوانه «كوكب المؤثرين». رصدتْ مؤلفته جرمين عامر تنامى تأثير هذه الكائنات الإليكترونية علينا، وذكرتْ أن حجم سوق «الإنفلونسرز» تجاوز 15 مليار دولار عالميا عام 2022، ومن المتوقع أن يكسر حاجز الـ 22 مليارًا العام الحالى! مما يعنى أن عدد ضعفاء النفوس من أمثالى يتزايد بمعدلات متسارعة.
بضاعة أتلفها.. هوانا!
منذ ابتكار البشر للتجارة تطوّرت أساليب الدعاية، وصارتْ صناعة متكاملة تستعين بكل وسائل التلاعب بأهوائنا، تنافست الشاشات على جيوبنا بإعلانات صارتْ مادة مشاهدة جذابة، ومن لا يشترى يكتفى بمتعة الفُرْجة. ثم جاء المؤثرون الجُدد بقوى سحرية تسلب قدرتنا على المقاومة، وهو ما تابعته جرمين عامر، ووضعتْ له أطرًا تنظيرية وتحليلية، مزجتْ فيها بين الإحصاءات ونظريات التسويق، واستخرجتْ من الأفلام القديمة نماذج لممثلين، اعتبرتهم الجيل الأول لكائنات المؤثرين، وقدّمت وصفاتٍ للراغبين فى استثمار قدراتهم بهذا المجال الوليد. شخصيًا أعتقد أن أعمار الكثير من المغامرين فى هذا المجال قصيرة، بعد أن أثبتتْ التجارب المتتابعة أن «التريند ابن موت»، مثلما تُطلق ثقافتنا الشعبية على من يفقد حياته فى سنٍ مُبكرة.
قبل أسابيع قرأت تقريرًا مهمًا عن حركات رفض عالمية بدأت تنتفض فى مواجهة المؤثرين، نتيجة اكتشاف آلاف البشر أنهم تحولوا إلى ضحايا عمليات إنفاق غير مُبرّرة، ولأن شهية بنى آدم وبناته انفتحت على الشراء، فقد أفرزت المصانع منتجاتها بكثافة مبالغ فيها. قادة الثورة ضد الباعة الجائلين فى دروب المواقع الإليكترونية ضربوا مثالًا بصناعة الملابس، وأشاروا إلى إنتاج أكثر من مائة مليار قطعة كل عام على مستوى العالم، ينتهى المطاف بنصفها إلى مقالب النفايات، لأنها زادتْ عن طاقتنا الاستهلاكية، أو لأننا اشتريناها دون رغبة حقيقية فى استخدامها.
يقطع الهاتف تنظيراتى بنغمة مميزة. زوجتى تلاحقنى بعد أن قرأت الرسالة، أعرف أن اللحظات التالية لن تخلو من عبارات اللوم المعتادة. أقرّر الهرب من جديد، حتى تتجاوز انفعالها، والحجة فى آخر اليوم جاهزة.. ضغط العمل الكثيف هو المحرض الأساسى على جريمة عدم الرد!
بائع البليلة
الإثنين:
فى الليل تبدو أضواء المدينة ساحرة. أقف خلف زجاج مكتبى فى الجريدة، أتطلع لما تيسّر من مبانى وسط البلد. بعد انتهاء العمل تكتسى الحياة بملامح مغايرة، أصبح أكثر تفاعلًا مع مفردات أرهقتْها توترات اليوم الممتد. لا أضيق بالضجيج المتصاعد فى الشارع، رغم أنه يصل بى إلى حافة الجنون على مدار اليوم. تختلط ضوضاء السيارات بأصوات البشر العالية، ويبدو الجميع فى حالة منافسة حامية على تصنيع الصخب.
فى سنوات الشباب، كنتُ أقضى الليل كله أحيانا فى شارع الصحافة، أستمتع بهدوئه الاستثنائى بعد الواحدة صباحًا، خاصة فى ليالى الشتاء، عندما يمنح الصمت للمكان فرصة استعراض عضلات جمالياته. حتى المقاهى تكشف عن فتنتها بعد أن يغادرها المزعجون، ويقتصر الحضور فيها على من أجهدهم التعب!
إنها الثامنة مساء. سيعلو صوته العذب كالمعتاد فى التوقيت ذاته، ينادى على «البليلة» التى يبيعها، يذكر أنواعها ويصف محاسنها كأنه يتغزل فيها، لا أستطيع رؤيته من النافذة المصمتة، غير أن النبرة توحى بأنه كبير السن، ينتمى لآخر أجيال الباعة الفنانين، ممن يمارسون حرفتهم بشغف لا يقتصر على مجرد «أكل العيش». نادرًا ما انقطعتْ نداءاته منذ يبدأ وصولها إلى مسامعى حتى تغيب، انسيابها المتواصل يوحى بأن الرجل لم يجد من يمنحه وقتًا مُستقطعًا لصمتٍ يصاحب عملية بيع. ومع ذلك يواصل رحلته الأبدية.
أكتشف أن حاسة السمع صارت الأكثر سيطرة علىّ. فى هذه اللحظة أتساءل عن فضولى المتكاسل، الذى لم يدفعنى يومًا إلى النزول من برجى العاجى، كى ألقى نظرة على هذا البائع الذى أدمنتُ سماع صوته. أتجّه مُسرعا إلى المصعد لكن قرارى جاء متأخرًا كالعادة. عندما وصلتُ إلى الشارع كان بائع البليلة قد هرب من مطاردتى المؤجّلة.. ربما أبقى بانتظاره فى ليلٍ آخر.
موسيقى الذكريات
الثلاثاء:
منذ فترة أحاول الإفلات من دوائر الشجن، مقتنعًا أن الإفراط فى تعاطى جرعات الحنين غير مُستحب فى مثل عُمرى. صرتُ أتفادى أى تماسٍ مع الطرب القديم، لأنه غالبًا المفجّر الأساسى لدوامات أحاسيس داكنة، تعود بى إلى أزمنة اختبأتْ فى دهاليز الذاكرة. الهروب ليس ممكنًا فى كل مرة، فالأغنيات تسعى لمن يفرّ منها، مثل «عفريت» مولع بالظهور لمن يخشاه.
«ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنى؟». تهاجمنى الجُملة الاستفسارية بعد ضغطة على «الريموت كونترول». تحت سطوة حالة استرخاء على السرير، أستسلم مؤقتًا للحنٍ يأسرنى منذ سمعته أول مرةٍ ذات ماضٍ سحيق. أشعر أن «عينيا يجافيها النوم»، رغم أنه كان يراودهما عن نفسهما قبل لحظات، وكأن الأرق عدوى تنتقل عبر الكلمات. ولأن الفرار يحتاج إلى قرار حاسم، أرفع «الريموت كونترول» من جديد، كى يُنهى حالة انسياب الشجن. فجأة تتصاعد نغمات تلك الآلة التى استطاعت أن تُزاحم عشقى للوتريات، انجذبتُ لـ «الأكورديون» منذ طفولتى، بقُدرته الفائقة على الجمع بين طاقة شجن تحتلنى، وإيقاع راقصٍ يتأرجح على الحافة بين الطرب والمجون! ربما لأنه يشبه طبيعتنا البشرية بمتناقضاتها، تمامًا مثل آلة القانون، التى ابتكرتْ لنفسها أسطورة تليق بها، وعندما كشف مخترعها عنها، عزف عليها فضحك المستمعون، وسكت للحظات ثم استأنف العزْف فبكى الجميع.
ظل «الأكورديون» هو الآلة الغربية الوحيدة التى أسرتْنى، لم تربطنى بـ «البيانو» مثلًا علاقة طيبة، ربما لسماته الأرستقراطية التى تجعلنى أرفض زهوه المبالغ فيه، ولا جذبنى «الجيتار» رغم جنون إيقاعاته التى تتناسب مع بعض حالاتى. استثناءات قليلة استمتعتُ فيها بالآلتين، تحت رعاية العُمريْن: خيرت وخورشيد!
«أنا قلبى بيسألني.. إيه غيّر أحواله»، أنتبه إلى أن الشاشة لا تزال تحت سيطرة الأغنية، أشعر بالامتنان للآلة الموسيقية التى خطفتنى من دائرة الشجن إلى دوائر الأفكار.. وأقلب القناة بسرعة!
«اسأل عن اللى يقضّى الليل.. بين الأمل وبين الذكرى.. يصبّر القلب المشغول.. ويقول له نتقابل بكرة»!! تستحضر ذاكرتى بقية كلمات الأغنية، وتسخر من فيلم أجنبى حاولتُ الانشغال به. تمنعنى عن التفاعل مع مغامرات بطله الخارق، وتؤكد لى أن «لكْمة» شجنٍ واحدة، أقوى من طلقات مدافع تدوى خلف الشاشة، وتصرع العشرات فى لحظات.
لماذا لم يخترغ البشر حتى الآن «ريموت كونترول»، ينجح فى تبديد سطوة الأفكار بضغطة زرٍ واحدة؟!
*يوميات الأخبار